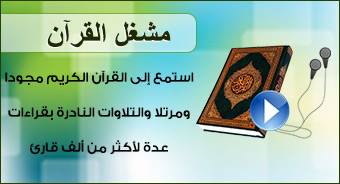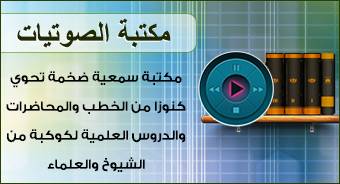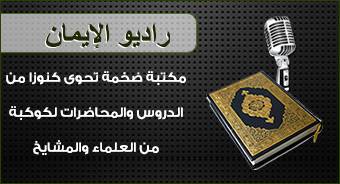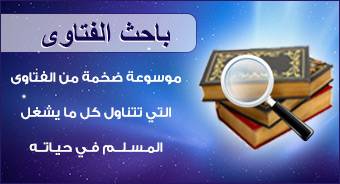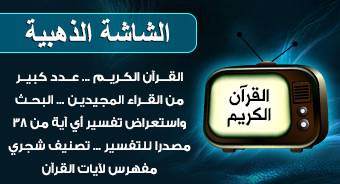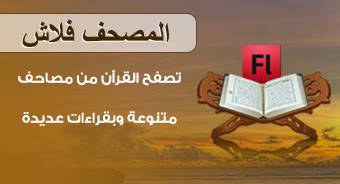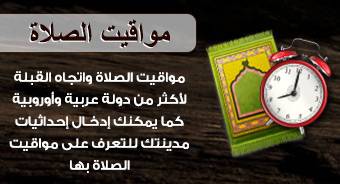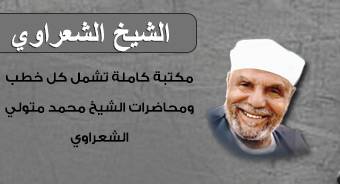|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقال غيره مشيراً إلى أن الكدح فيه معنى النصب: ويشهد لهذا قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان فِي كَبَدٍ} [البلد: 4]، كما قدمنا في محله.تنبيه:من هذا العرض القرآني الكريم من مقدمة تغيير أوضاع الكون سماء وأرضاً، ووضع الإنسان في يكدح إلى ربه كدحاً فملاقيه، أي بعمله الذي يحصل عليه من خلال كدحه، فإن العاقل المتبصر لا يجعل كدحه إلاّ فيما يرضي الله ويرضي هو به، إذا لقي ربه ما دام أنه كادِحٌ، لا محالة كما هو مشاهد.تنبيه آخر:قوله تعالى: {يا أيها الإنسان} عام في الشمول لكل إنسان مهما كان حاله من مؤمن وكافر، ومن بر وفاجر، والكل يكدح ويعمل جاهد التحصيل ما هو مقبل عليى، كما في الحديث: «اعملوا كل ميسر لما خلق له» أي ومجد فيه وراض به، وهذا منتهى حكمة العليم الخبير.ومما هو جدير بالتنبيه عليه، هو أنه إذا كانت السماء مع عظم جومها، والأرض مع مساحة أصلها أَذِنَتْ لربها وَحُقَّتْ، مع أنها لم تتحمل أمانة، ولن تسأل عن واجب فكيف بالأنسان على ضعفه، {أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السماء} [النازعات: 27]، وقد تحمل أمانة التكليف فأشفقن منها وحملها الإنسان، فكان أحق بالسمع والطاعة في كدحه، إلى أن يلقى ربه لما يرضيه.{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابهُ بِيَمِينِهِ (7)}في هذا التفصيل بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه، وما سجل عليه في كتاب أعماله، وذلك بعد أن تقدم في الانفطار قوله: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الأبرار لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 10-14].وجاء في المطففين {كَلاَّ إِنَّ كتاب الفجار لَفِي سجين} [المطففين: 7] ثم بعده {كَلاَّ إِنَّ كتاب الأبرار لَفِي عِلِّيِّينَ} [المطففين: 18].جاء هنا بيان إتيانه هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه السور بعضها ببعض، في بيان مآل العلم كله ومصير الإنسان نتيجة عمله.وتقدم للشيخ مباحث إتيان الكتب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر، عند كل من قوله تعالى: {يوم نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بإمامهم} [الإسراء: 71] في سورة الإسراء- إلى قوله تعالى- {فَمَنْ أُوتِيَ كتابهُ بِيَمِينِهِ} [الإسراء: 71]، وبين أحوال الفريقين أهل اليمين وأهل الشمال، وأحال على أول السورة.وقوله: {وَوُضِعَ الكتاب فَتَرَى المجرمين مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ} [الكهف: 49]، في سورة الكهف وهنا ذكر سبحانه وتعالى حالة من حالات كلا الفريقين.فالأولى: يحاسب حساباً يسيراً وهو العرض فقط دون مناقشة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذّب»والثانية: يدعو على نفسه بالثبور وهو الهلاك، ومنه: المواطأة على الشيء سميت مثابرة، لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه.وهنا مقابلة عجيبة بالغة الأهمية، وذلك بين سرورين أحدهما آجل والآخر عاجل.فالأول في حق من أوتي كتابه بيمينه، أنه ينقلب إلى أهله مسروراً ينادي فرحاً {هَآؤُمُ اقرؤا كتابيَهْ} [الحاقة: 19]، وأهله آنذاك في الجنة من الحور والولدان، ومن أقاربه الذين دخلوا الجنة، كما في قوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ} [الرعد: 23].وقوله: {والذين آمَنُواْ واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21]، فهم وإن كانوا ملحقين بهم إلا أنهم من أهلهم، وهذا من تمام النعمة أن يعلم بها من يعرفه من أهله، وهذا مما يزيد سرور العبد، وهو السرور الدائم.والآخر سرور عاجل، وهو لمن أعطوا كتبهم بشمالهم، لأنهم كانوا في أملهم مسرورين في الدنيا، وشتان بين سرور وسرور.وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنيا، بأنهم يصلون سعيراً، ولم يبين سبب سرور الآخرين، ولكن ينبه في موضع آخر وهو خوفهم من الله في قوله تعالى: {قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السموم إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البر الرحيم} [الطور: 26-28].وهنا يقال: إن الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفان، ولم يعطه الأمنان معاً، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46].{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفس عَنِ الهوى فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى} [النازعات: 40-41].ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فيؤتى كتابه بشماله ويصلى سعيراً، كما في قوله تعالى: {وَأَصْحَابُ الشمال مَآ أَصْحَابُ الشمال فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ على الحنث العظيم وَكَانُواْ يِقولونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أإنا لَمَبْعُوثُونَ} [الواقعة: 41-47]، تكذيباً للبعث. وقوله هذا هو بعينه المذكور في الآيات {إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ}. وقوله: {إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُور}، هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين {أَلا يَظُنُّ أولئك أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ} [المطففين: 4-5]، مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه، هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل المصحف {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] الآيات.في هذا التفصيل بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه، وما سجل عليه في كتاب أعماله، وذلك بعد أن تقدم في الانفطار قوله: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الأبرار لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الفجار لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 10-14].وجاء في المطففين {كَلاَّ إِنَّ كتاب الفجار لَفِي سجين} [المطففين: 7] ثم بعده {كَلاَّ إِنَّ كتاب الأبرار لَفِي عِلِّيِّينَ} [المطففين: 18].جاء هنا بيان إتيانه هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه السور بعضها ببعض، في بيان مآل العلم كله ومصير الإنسان نتيجة عمله.وتقدم للشيخ مباحث إتيان الكتب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر، عند كل من قوله تعالى: {يوم نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بإمامهم} [الإسراء: 71] في سورة الإسراء- إلى قوله تعالى- {فَمَنْ أُوتِيَ كتابهُ بِيَمِينِهِ} [الإسراء: 71]، وبين أحوال الفريقين أهل اليمين وأهل الشمال، وأحال على أول السورة.وقوله: {وَوُضِعَ الكتاب فَتَرَى المجرمين مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ} [الكهف: 49]، في سورة الكهف وهنا ذكر سبحانه وتعالى حالة من حالات كلا الفريقين.فالأولى: يحاسب حساباً يسيراً وهو العرض فقط دون مناقشة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذّب»والثانية: يدعو على نفسه بالثبور وهو الهلاك، ومنه: المواطأة على الشيء سميت مثابرة، لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه.وهنا مقابلة عجيبة بالغة الأهمية، وذلك بين سرورين أحدهما آجل والآخر عاجل.فالأول في حق من أوتي كتابه بيمينه، أنه ينقلب إلى أهله مسروراً ينادي فرحاً {هَآؤُمُ اقرؤا كتابيَهْ} [الحاقة: 19]، وأهله آنذاك في الجنة من الحور والولدان، ومن أقاربه الذين دخلوا الجنة، كما في قوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ} [الرعد: 23].وقوله: {والذين آمَنُواْ واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21]، فهم وإن كانوا ملحقين بهم إلا أنهم من أهلهم، وهذا من تمام النعمة أن يعلم بها من يعرفه من أهله، وهذا مما يزيد سرور العبد، وهو السرور الدائم.والآخر سرور عاجل، وهو لمن أعطوا كتبهم بشمالهم، لأنهم كانوا في أملهم مسرورين في الدنيا، وشتان بين سرور وسرور.وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنيا، بأنهم يصلون سعيراً، ولم يبين سبب سرور الآخرين، ولكن ينبه في موضع آخر وهو خوفهم من الله في قوله تعالى: {قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السموم إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البر الرحيم} [الطور: 26-28].وهنا يقال: إن الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفان، ولم يعطه الأمنان معاً، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46].{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفس عَنِ الهوى فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى} [النازعات: 40-41].ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فيؤتى كتابه بشماله ويصلى سعيراً، كما في قوله تعالى: {وَأَصْحَابُ الشمال مَآ أَصْحَابُ الشمال فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ على الحنث العظيم وَكَانُواْ يِقولونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أإنا لَمَبْعُوثُونَ} [الواقعة: 41-47]، تكذيباً للبعث. وقوله هذا هو بعينه المذكور في الآيات {إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ}. وقوله: {إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُور}، هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين {أَلا يَظُنُّ أولئك أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ} [المطففين: 4-5]، مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه، هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة كما في مستهل المصحف {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] الآيات.{فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)}الشفق: لغة: رقة الشيء.قال القرطبي: يقال شيء شفيق، أي لا تماسك له لرقته، وأشفق عليه أي رق قلبه عليه، والشفقة الاسم من الإشقاق وهو رقة القلب، وكذلك الشفق.قال الشاعر: فالشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها، فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس.ونقل عن الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة إذا ذهب.قيل: غاب الشفق. اه.وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة في توقيت وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، وهو الحمرة بعد الغروب، كما قال الخليل.وعند أبي حنيفة رحمه الله: أن الشفق هو البياض الذي بعده.وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في بيان أوقات الصلوات الخمس عند قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الحمد فِي السماوات والأرض وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17-18]، ورجح أن الشفق: الحمرة.ونقل القرطبي قولاً، قال: وزعم الحكماء أن البياض لا يغيب أصلاً.وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب.وقال ابن أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر، ثم قال: قال علماؤنا: فلما لم يتجدد وقته سقط اعتباره. اهـ.فهو بهذا يرجح مذهب الجمهور في معنى الشفق، والنصوص في ذلك من السنة فيها مقال.فقد روى الدارقطني حديثاً مرفوعاً: (الشفق الحمرة)وتكلم عليه الشوكاني ثم ذكر من يقول به من الصحابة وهم ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعبادة. ومن الأئمة: الشافعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو سيف ومحمد، من الفقهاء، والخليل والفراء من أهل اللغة.فأنت ترى أن أبا يوسف ومحمداً من أصحاب أبي حنيفة وافقا الجمهور.وفي شرح الهداية أيضًا: رواية عن أبي حنيفة.أما ما ذكره القرطبي ففيه نظر، أي من جهة عدم غياب البياض، فإن المعروف عند علماء الفلك أن بين الأحمر والأبيض مقدار درجتين، والدرجة تعادل أربع دقائق، وعليه فالفرق بسيط، والله تعالى أعلم.وقوله: {والليل وَمَا وسق} [الانشقاق: 17]، هو الجمع والضم للشيء الكثير، ومنه سمي الوسق بمقدار معين من مكيل الحب، وهو ستون صاعاً.وقيل: فيه معان أخرى، ولكن هذا أرجحها.والمعنى هنا: والليل وما جمعه من المخلوقات. قيل: كأنه أقسم بكل شيء كقوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ} [الحاقة: 38- 39].وقوله: {والقمر إِذَا اتَّسَقَ}، أي اتسع أي تكامل نوره، وهو افتعل من وسق، والقاعدة الصرفية أن فاء الفعل المثالي، أي الذي فؤه واو، إذا بني على افتعل تقلب الواو تاء وتدغم التاء في التاء، كما في: وصلته فاتصل ووزنته فاتزن، أو تصل أو تزن، وهكذا هنا أو تسق.وقوله: {لتركبن طبقا عَن طبق}.قال ابن جرير: اختلف القراء في قراءته، فقرأه عمر بن الخطاب وابن مسعود وأصحابه وابن عباس وعامة قراء مكة والكوفة {لتركبن} بفتح التاء والباء، واختلف قارئوا ذلك في معناه، فقال بعضهم: يعني يا محمد، ويعني حالات الترقي والعلو والشدائد مع القوم، وهذا المعنى عن مجاهد وابن عباس.وقيل: {طبقا عن طبق}: يعني سماء بعد سماء، أي طباق السماء، وهو عن الحسن وأبي العالية ومسروق.وعن ابن مسعود: أنها السماء تتغير أحوالها تتشقق بالغمام، ثم تحمر كالمهل، إلى غير ذلك. وقد رجح القراءة الأولى والمعنى الأول.وقرأ عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين: {لتركبن} بالتاء وبضم الباء على وجه الخطاب للناس كافة.وذكر المفسرون لمعناه حالاً بعد معان حال معان عديدة طفولة وشباباً وشيخوخة، فقرا وغنى، وقوة وضعفاً، حياة وموتاً وبعثاً، رخاء وشدة، إلى كل ما تحتمله الكلمة.وقال القرطبى: الكل محتمل، وكله مراد، والذي يظهر والله تعالى أعلم: أن ذلك إنما هو بعامة الناس ويكون يوم القيامة، إذ السياق في أصول البعث، إذا السماء انشقت، وإذا الأرض مُدَّتْ، فأما من أوتي كتابه بيمينه وذكر الحساب المنقلب، ثم التعبير بالمستقبل، لتركبن، ولو كان لأمر الدنيا من تغير الأحوال لكان أولى به الحاضر أو الماضي، وإن كان من المستقبل ما سيأتي من الزمن لكنه ليس بجديد، إذ تقلب الأحوال في شأن الحياة أمر مستقر في الأذهان، ولا يحتاج إلى هذا الأسلوب.أما أمور الآخرة من بعث، وحشر، وعرض، وميزان وصراط وتطاير كتب، واختلاف أحوال الناس باختلاف المواقف، في عرصات القيامة فهى الحرية بالتنبيه عليها وبالتحذير منها والعمل لأجلها في كدحه إلى ربه، فلذا جاء بذلك وهو مشعر باستمرار حالة اللإنسان بعد الكدح إلى حالات متعددة ودرجات متفاوتة.ولو اعتبرنا حال المقسم به من حيث تطور الحال من شفق أو آخر ضوء الشمس ثم ليل، وما جمع وغطى بظلامه، ثم قمر يبدأ هلالاً إلى اتساق نوره، لكان انتقالاً من تغير حركات الزمن إلى تغير أحوال الإنسان قطعاً، وأن القادر على ذلك في الدنيا قادر على ذلك في الآخرة.{إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25)}قيل: المن: القطع والنقص، ومنه قول الشاعر: والقهد: ضرب من الضأن تعلوه حمرة صغيرة آذانه، والكواسب: الوحوش، أي ذئاب أو سباع لا ينقطع طعامها.وقال القرطبي: مننت الحبل إذا قطعته.وسأل نافع بن الأزرق، ابن عباس عنها فقال: غير مقطوع، فقال هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم، قد عرفه أخو يُشْكرَ، حيث يقول: قال المبرد: المنين الغبار لأنها تقطعه وراءها.وقيل: غير ممنون أي غير ممنون به عليهم، لنكمل النعمة عليهم.وقال ابن جرير: غير ممنون أي غير محسوب ولا منقوص. وذكره ابن عباس ومجاهد.وقال ابن كثير: غير مقطوع، كقوله تعالى: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود: 108]، ورد قول من قال إنه غير ممنون به عليهم، لأن لله تعالى أن يمتن على عباده وهم ما دخلوا الجنة الا بفضل من الله ومنه عليهم. انتهى.ومما يهد لقول ابن جرير غير محسوب عموم قوله تعالى: {إنًّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 37] وخصوصه قوله تعالى: {وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك يَدْخُلُونَ الجنة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} [غافر: 40].قوله تعالى: {جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً} [النبأ: 36]، فهو بمعنى كافيا من قولك: حسبي بمعنى كافيني.والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلا من المعنيين مقصود ولا مانع منه، وما ذهب إليه ابن كثير لا يتعارض مع قول الآخرين، لأن المن الممنوع هو ما فيه أذى وتنقيص، كما في قوله: {ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى} [البقرة: 262]، أما المن من الله تعالى على عبده، فهو عين الإكرام والزلفى إليه سبحانه. والعلم عند الله تعالى. اهـ.
|